العالم قرية صغيرة في إمبراطورية أمازون
تكتب لما عن تجربتها مع التسوق الإلكتروني، وعن سلبيات كون العالم أصبح قرية صغيرة في إمبراطورية أمازون، وعن تجاوزات تلك الإمبراطورية.
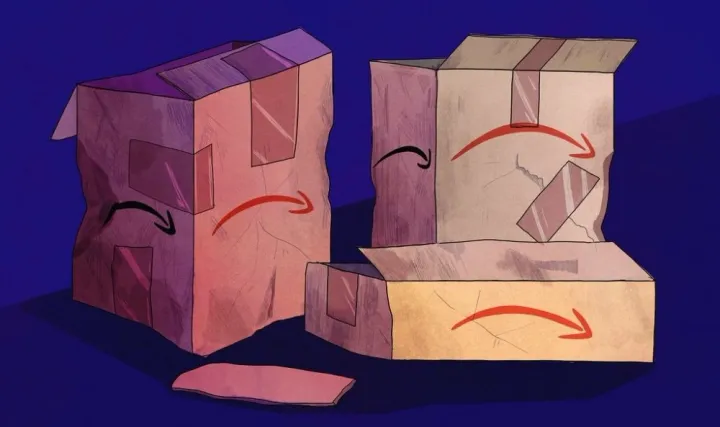
حين سافرتُ لاستكمال دراستي في الولايات المتحدة، دُهشت بأني أستطيع -أخيرًا- استقبال مشترياتي من على عتبة منزلي. وبتّ أفتح الصناديق مبتهجة لأعاين ما اشتريته قبل أيام بكبسة زر، تمامًا كما يفتحُ الأطفال هداياهم في الأفلام؛ متظاهرين بأنهم لا يعرفون ما في داخلها.
كل ما عرفته عن التسوق قبل ذاك كان المشيُ لساعاتٍ في السوق برام الله، حيث لا صناديق بريد منزلية. رفاهية التسوق المريح هذه لم أفكر يومًا في تبعاتها، إلا على رصيدي البنكي. ولم يخطر لي حينها ما الذي يحصل بين كبسة الزر الأولى على موقعٍ كـ«أمازون» ورنين جرس منزلي إنباءً بوصول المشتريات.
التكلفة الباهظة لإخفاقات أمازون
في سبتمبر 2017، في مستودع لشركة أمازون، سقطت رافعة شوكية على عامل صيانة وقتلته. بقيت جثته ملقاةً على الأرض ساعتين إلى أن وجدها أحد زملائه. بدأ التحقيق حينها في الحادثة، ليكشف أنّ العمال في ذاك المستودع لم يتلقوا تدريبًا لائقًا حول تدابير السلامة. لكن انتهت القضية بتبرئة أمازون ولوم العامل الميت نفسه على «سوء التصرّف».
تلك حادثة واحدة من حوادث رهيبة وقعت في مستودعات أمازون: الشركة التي بدأت ببيع الكتب عبر الإنترنت في التسعينيات ثم أصبحت إمبراطورية للتسوق، ويملكها جيف بيزوس، أغنى رجلٍ في العالم.
وحين نَصِفُ أمازون بإمبراطورية، فنحن لا نبالغ مجازًا. فرأسمالها السوقي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم، ولم تزِدها الجائحة إلا ثراءً وتوسعًا. إذ زادت أرباح الشركة بنسبة 200٪ إثر إغلاق المحال التجارية أبوابها وحصر التسوق على الإنترنت.
كشفت سجلات لمائة وخمسين مستودعًا لأمازون بين عامي 2016 و2019 أزمةً حقيقية في إصابات العمل المتزايدة. بالطبع حرصت الشركة على إخفاء الأزمة، وأعلنت عن استثمار ملايين الدولارات في تعزيز تدابير السلامة. إلا أن عام 2019 وحده سجّل أربعة عشر ألف إصابة خطيرة بين عمال الشركة. وبلغت نسبة تلك الإصابات في أمازون بالتحديد ضعف ما هي عليه في مجال الشحن والمنشآت المشابهة.
بقيت تلك الإصابات وظروف العمل القاسية طيّ الكتمان إلى أن تراكمت وترافقت معها إخفاقات أكبر حيال سلامة الموظفين خلال الجائحة. وهكذا، خلقت كل تلك الظروف محرّكًا لعمال أمازون في السنين القليلة الفائتة، ودفعتهم باتجاه خطوة تاريخية بلغت ذروتها الشهر الجاري في ولاية ألاباما.
لا نقابة لعمّال أمازون
عمالٌ في الشركة يحملون لافتات رُسمت عليها ابتسامة شعار أمازون مقلوبة رأسًا على عقب. صورةٌ تجسد سعي 5800 عامل وعاملة نحو الانضمام لأول نقابة تمثل موظفي هذه الشركة، بدءًا بمستودعهم في ألاباما.
اعتمد تحقيق هذا الحلم على انتخابات يصوت فيها العمال بـ«نعم» أو «لا» على انضمامهم للنقابة. ترقّب الجميع نتائج الانتخابات والتي انتهت بإعلان فوز «مَن قالوا لا» بأغلبية الأصوات، ما يعني أن النقابة لن تر النور.
لم تكن خسارة حلم النقابة لصالح أمازون مفاجِئة، إذ يعدّ دارسو الحقوق العمالية في أميركا تأسيس الأجسام النقابية الجديدة معجزة. فالشركات الكبرى تسعى بكلّ ثقلها ونفوذها لمنع تأسيسها، وتحث العمال، أو تهددهم غالبًا، على التصويت ضد أي مساعٍ مشابهة.
لماذا؟ لأنّ انتصار النقابيين في مستودع واحد لأمازون، ثاني أكبر مشغّل للعمال في أميركا، حتمًا سيتردد صداه في الولايات المتحدة بأكملها. لن يفتح البابَ للأحلام بأجورٍ أعلى وبالتفاوض على تحسين ظروف العمل في المستودعات الأخرى فحسب، بل سيؤثر ذلك الانتصار على ظروف العمل لدى كلّ منافسي أمازون. إذ سيجبرهم التنافس مع هذه الشركة العملاقة على تبنّي طريقتها في الإدارة وتحديد الأجور واستغلال الموظفين.
هشاشة العالم أمام السفينة العالقة
بعيدًا عن ألاباما بأميال، أغلقت سفينةٌ تزن مائتي وعشرين ألف طن المجرى الملاحي لقناة السويس. أغلقته لمدة أسبوع في مارس الماضي، واحتفل العالمُ بعد انقضاء الأزمة بـ«تحرير السفينة». غير أنها لم تتحرر فعليًّا، إذْ قررت مصر احتجازها لحين سداد تعويضات تقدَّر بتسعمائة مليون دولار طلبتها هيئة قناة السويس من الشركة المالكة.
مشهدُ السفينة وهي تسدّ شريانًا مهمًا للتجارة العالمية سيعلق، مثلما علقت السفينة، في ذهن العالم. رأينا سفينة كبيرة تملأ سطحَها حاوياتٌ ملونة، فيها أطنان من البضائع المعدّة للاستهلاك. حاوياتٌ حُملت عبر البلدان والبحار بداعي الاحتياج إليها، ضمن نظام شحنٍ يبدو عبقريًّا وقد صيَّر العالم «قرية صغيرة».
لكن خطأ واحدًا أعاق هذا النظام وأبرز هشاشته، ومعها الهشاشة التي يخلقها اعتماد التجارة على سلاسل توريد طويلة. حين تتعطل السلسلة، تتسبب بنقصٍ حادٍ في الإمدادات وارتفاعٍ في الأسعار، وتؤدي حتى إلى نقصٍ في حاويات شحن البضائع نفسها.
وبطبيعة الحال، لم تعلق هذه السفينة فحسب، بل لحقت بها، كقطعِ الدومِنو، عشراتُ السفن الأخرى التي انتظرت فتح القناة. وعلى الأغلب وصلت موانئها بعد الأزمة متأخرةً معًا، مستدعيةً ازدحامًا جديدًا بانتظار تفريغها من حمولتها.
في تعليقه على حادثة السويس في نيويورك تايمز، قال إيان قولدِن، أستاذ في جامعة أكسفورد: «كلما كنّا أكثر ترابطًا، أصبحنا أكثر عرضة لنقاط الهشاشة، والتي دائمًا ما تكون غير متوقعة»، ويقصد بنقاط الهشاشة حوادث كالسفينة العالقة. وأيضًا، وفق قولدن، ينطبق وصف الهشاشة ذاته على وباء كورونا. إذ تتيح العولمة، بحدودها المفتوحة، سيلًا جارفًا ينقل الأفكار والأشخاص والبضائع ومعها الأمراض والمخاطر.
ما بين كبسة الزر ورنين جرس الباب
أنا في مقهى عربي أحتسي الإسبرسو الإيطالي وأستمعُ لأغنية روك بريطانية، أتحجج حين تهربُ مني الأفكار بتلميع عدسة نظارتي، التي أقسم البائع بأنها تركية. أفكّر بالسؤال الأساسي لهذا المقال: «طيب يعني، ما الذي يحدث بين ضغطك على الزر، وسماعك رنين جرس منزلك؟»
مبدئيًا، أعرف الآن أن لحظة فتحِ الصناديق على عتبة منزلي ليست نهايةً لقصة سعيدة، هي فقط نهاية لسلسلة توريدٍ ما. أعرفُ أننا نعيشُ في عالم تسود فيه عمليات الإنتاج على البشر، أي تسود أهداف أمازون الإنتاجية الخيالية على سلامة الموظفين. وأعلمُ أن العديد من البشر منخرطون، وعلى الأرجح مستغَلّون، في عملية حصولي على أي سلعة، مهما كانت تافهة.
وأعلمُ أنّ معرفة محتويات السفينة العالقة رسمت ابتسامة ساخرة على وجهي. فالسفينة حملت، ضمن ما حملت، النفط وآلات للتمارين الرياضية وأثاثًا من تصنيع آيكيا وقهوة فورية وحليب جوز الهند. جرد البضائع عليها بدا وكأنه تعبيرٌ تهكميّ عن العالم الاستهلاكي الحديث. وفي المحصلة، أوقن أنَّ المستهلكين هم من دفعوا ثمن تأخير السفن وخسائرها.
أكلّم نفسي فتسمعني صديقتي، طالبة في علم الاجتماع وتجلس قبالتي، فترد: «أنتِ تتحدثين عن “صَنَمية السلعة”، أليس كذلك؟». فترجعني إلى ما ذكره كارل ماركس في كتابه «رأس المال» إذ يقول: «تظهر السلعة للوهلة الأولى على أنّها شيء بديهي، بل تافه. غير أنّ تحليلها يُظهِر لنا شيئًا شديد الغرابة.»
بقوله هذا، يجادل ماركس أنّ قيمة أي منتج لا تكمن في سعره، والذي اعتدنا ارتفاعه وانخفاضه بناءً على العرض والطلب. بل تكمن قيمة المنتج في العمل المبذول خلال عملية الإنتاج.
القيمة الحقيقية في حذاء نايكي
طبقت تمرينًا بسيطًا على نظرية ماركس. واخترت سلعةً واحدة حتى أحللها وأجد ذاك الشيء «شديد الغرابة» الذي تحدث عنه. فاخترت حذاء صديقتي؛ حذاء نايكي عادي. السلعة تبدو بسيطة فعلًا، وعلى الأغلب سيهترئ الحذاء قريبًا، لتستبدله صديقتي بزوجِ أحذية آخر بسهولة.
كانت اشترته من مركز تسوقٍ قريب، وهو بالتأكيد مستورد، ما يعني أنّ السلعة حتى الآن تحملُ في قيمتها عمل البائعة في المتجر، وجهد عمّال الشحن ومستودعات التخزين.
لكننا لا نستطيع معرفة من صنعها، لأن سلسلة التوريد في نايكي تضم أكثر من سبعمائة مصنع في أكثر من اثنين وأربعين دولة. وعلى الأرجح صانعة الحذاء امرأة، لأنّ أغلب عمال نايكي من النساء بين التاسعة عشر والخامسة والعشرين من العمر. ولطالما حذّر الصحفيون من مصانع نايكي وغيرها من الشركات «العابرة للجنسيات» ومن استغلالها للعمال الفقراء في آسيا وإفريقيا. فهؤلاء العمال ينتجون بضائع يستحيل عليهم شراؤها، وفي ظروف عملٍ قاسية وبأجورٍ بخسة.
وآخر تلك الاتهامات لنايكي نُشرت عام 2020، حول استغلالها عمالًا من أقلية الإيغور المجبرين على العمل بالسخرة والقادمين من مخيمات الاحتجاز الصينية.
تسمي الشركات هذا النمط من الإنتاج «الاستعانة بمصادر خارجية» (Outsourcing)، وتعده الطريق لتحقيق الجودة ضمن تكاليف إنتاج منخفضة. فمثلًا، تحوّل شركة أميركية مصانعها إلى دول في قاراتٍ مختلفة، أفقر غالبًا، معتمدة على التقنيات الجديدة التي صيَّرت الإدارة والتواصل عن بُعد ونقل السلع والشحن أسهل وأسهل، تمامًا كما السفينة العالقة، قبل أن تعلَق.
القرية وكرة أمازون الزجاجية
أذكر في الصف الخامس، درسنا في المنهاج الرسمي مقالًا ركيكًا عنوانه «العولمة: كيف أصبح العالم قرية صغيرة؟» وفي العام ذاته، اشترت لي أمي كرة ثلجٍ زجاجية؛ تلك التي تطوّق فيها قبة زجاجية قرية صغيرة. الكرة ساحرة، خاصة حين تهزها هزَّة قوية، وما إن هززتُها حتى تخيلتُ العولمة في الدرس: ثلجٌ رقيق متناثر على الجميع. لكن حين كبرت عرفت أنها ليست على ذاك القدر من السحر.
حين نهز العالم المترابط جدًا حدّ الهشاشة، بوباءٍ أو بأزمة شحن أو تسونامي، لا يتأثر كل من تحت القبة الزجاجية بالقدر ذاته. أجل، قد يكون العالم قرية صغيرة حيث تبني الشركات الكبرى سلاسل وثيقة تربط العالم بعضه ببعض، لكنها في الحقيقة «تقيّد بعضه ببعض»، حتى يصبح جسدًا واحدًا مدرًّا للربح. لكن الربح لمن؟ لأغنى رجلٍ في العالم، مثلًا.
